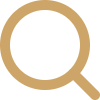من الصمت إلى الضجيج
في وقت كان فيه المشهد الموسيقي السعودي محكومًا بالصمت والتحفّظ، ظهرت Creative Waste كصرخة فنية غير قابلة للترويض.
فرقة قررت أن تصنع موسيقى لا تطلب الإذن، وأن تحمل الميتال المتطرف من غرف مغلقة إلى منصات عالمية، لتكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الروك السعودي.
جذور في أرض صلبة
ولدت فكرة Creative Waste في أواخر التسعينيات، لكن عام 2002 كان لحظة التحول الحقيقية. من المنطقة الشرقية، وفي بيئة لا تعترف بموسيقى الميتال، بدأت الفرقة ببناء صوتها الخاص، خطوة بعد خطوة، حتى صنعت حدثًا غير مسبوق بتقديم أول حفل ميتال علني في السعودية.
موسيقى بلا حدود
لم تعرف مسيرة Creative Waste معنى الاكتفاء بالمحلي. عبر العروض الخارجية والمشاركات الدولية، تحوّل اسم الفرقة إلى توقيع سعودي حاضر في مشهد الـGrindcore العالمي.
موسيقى مباشرة، عدوانية، محمّلة برسائل سياسية واجتماعية، وجدت صداها لدى جمهور يبحث عن الصدق قبل الشهرة.
أعمال تصرخ ولا تساوم
مثّل ألبوم Condemned لحظة نضج فني فارقة، حيث التقت القسوة الموسيقية بجودة إنتاج عالية بعد تسجيله في البحرين. ولم تتوقف الرحلة عند الألبومات، إذ عززت مشاركات الفرقة في إصدارات عالمية مثل A Tribute to Nasum حضورها بين أسماء الميتال المتطرف حول العالم.
استقلالية كخيار وجودي
بالنسبة إلى Creative Waste، لم تكن الاستقلالية قرارًا مهنيًا فقط، بل موقفًا فنيًا. بعيدًا عن شركات الإنتاج الكبرى، احتفظت الفرقة بحقها الكامل في التعبير، وأسهمت في الوقت نفسه في فتح الطريق أمام جيل سعودي جديد وجد في تجربتها دليلًا على أن الميتال ليس مستحيلًا محليًا.
إرث يتجاوز الموسيقى
قصة Creative Waste هي قصة فرقة كسرت القالب قبل أن تكسره الموسيقى نفسها، من المنطقة الشرقية إلى خرائط الميتال العالمية، أثبتت أن الصوت السعودي قادر على أن يكون عاليًا، صادقًا، ومؤثرًا… مهما كان قاسيًا.